سردٌ لبعض التَّعريفات:
أولاً: التحديدُ اللُّغويُّ لمصطلح الكفاية:
ولا بأسَ أن نُشيرَ إلى معنى (الكِفاية) في لُغتنا - في اللُّغة العربيَّة - فإنَّ أهمَّ تعريفٍ للكِفَاية أو الكَفَاءة هو الذي يُورِدُه ابنُ منظورٍ في "لسان العرب" (دار الجيل، بيروت، المجلد الخامس، ص269)؛ حيثُ ذكر قولَ حسَّان بن ثابتٍ: "ورُوحُ القُدُسِ ليس له كِفاء؛ أي: جبريلُ - عليه السَّلام - ليس له نظيرٌ ولا مَثيلٌ، والكَفِيءُ: النظير، وكذلك الكُفْءُ، والمصدر: الكَفَاءة، والكفاة: النظير والمساوي؛ يقول تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 3-4]، ويقالُ: كَفَأْتُ القِدْرَ وغيرَها: إذا كَبَبْتُها لتُفْرِغَ ما فيها، الكُفَاة: الخَدَمُ الذين يقومون بالخدمة، جمع كافٍ، وكَفَى الرَّجُلُ كِفَايةً، فهو كافٍ، إذا قام بالأمر.
ثانيًا: مفهومُ الكِفاية في مجال الثَّقافة العربيَّة:
دلالةُ المفهوم عند ابنِ خلدون:
يقولُ عبدُالرحمن بنُ خَلْدون: "الحَذْقُ في التَّعليم والتَّفنُّن فيه، والاستيلاءُ عليه - إنَّما هو بحصول مَلَكَةٍ في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوفِ على مسائِلِه، واستنباط فروعه مِن أصوله، وما لم تَحصلْ هذه الملكةُ لم يكن الحَذْقُ في ذلك الفنِّ المتناول حاصلاً، وهذه المَلَكَةُ هي في غير الفَهم والوعي، ولأنَّا نجدُ فَهْمَ المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيَها مشتركًا بين مَن شَدَا في ذلك الفنِّ وبين مَن هو مُبْتَدِئٌ فيه، والمَلَكَة إنما هي للعالِم أو الشَّادِي في الفنون دون مَن سواهما".
يُلاحَظُ مِن نصِّ المقدِّمة أنَّ الكِفَاية عند ابنِ خَلدون حاصلةٌ لمن له الملكة، وكان شاديًا في تخصُّصٍ مُعيَّن.
مفهومُ الكِفَاية في مجال الاقتصاد:
كلُّ الكِتَاباتِ الأُولَى حولَ الكِفَايات كان يَطغَى عليها الخطابُ المقاولاتي؛ مما يَدُلُّ على أنَّ المفهومَ كان وليدَ هذا المجال، ويُلَخِّصُ (فيليب كاري 1994Philippe Carré) الأسبابَ التي أدَّتْ إلى ظهور مفهومِ الكِفَاية فيما يلي:
Ÿ السبب الأول: مرتبطٌ بسياق المُقاوَلة وظروفِها، وبتطَوُّر الأسواق وتوقعات المستهلكين؛ مِن حيثُ الحاجَاتُ والضُّغوط الممارسة على المقاولات.
Ÿ السبب الثاني: مُتعلِّقٌ بتطوُّر أساليب التنظيم؛ حيثُ تَمَّ التَّخلي تدريجيًّا عن النِّظام (التايلوري).
Ÿ السبب الثالث: مرتبطٌ بالمُمَارَسات داخل التَّنظيماتِ؛ أي: بالحركة الضَّروريَّة داخل المقاولات.
Ÿ السبب الرابع: يَخُصُّ التدبيرَ التَّوقُّعِي؛ أي: النظرة المستقبليَّة وما يُتوقع من تطورات.
ولِمَا أَحرزَه توظيفُ مفهوم الكفاية في هذا المجال على المردوديَّة والجودة، كان لا بُدَّ من نقلةٍ إلى مَيدَان التَّربية.
تحديدُ مفهومِ الكِفاية في مجال التربية:
يُشيرُ "القاموسُ الموسوعيُّ للتَّربية والتَّكوين" أنَّ الكفايةَ compétence هي الخاصية الإيجابيَّةُ للفرد، والتي تَشهدُ بقدرتِه على إنجاز بعضِ المهام، ويُضيفُ أنَّ الكفاياتِ شديدةُ التنوُّع، فنجد الكفاياتِ العامَّةَ compétences générales القابلةَ للتحويل، والمُسهلة لإنجاز مهامَّ عديدة، كما نجدُ الكفاياتِ النَّوعيَّةَ أو الخاصَّة compétences spécifiques التي لا تُوَظَّفُ إلا في مهامَّ خاصَّةٍ جدًّا، وهناك كفاياتٌ تُسهِّلُ التَّعَلُّمَ وحلَّ المشكلات، وأخرى تُيَسِّرُ العَلاقاتِ الاجتماعيَّةَ والتَّفاهُمَ بين الأفراد.
ويمكنُ القولُ إجمالاً: إنَّ الكِفَايةَ في المنظور السُّلوكيِّ هي المهامُّ والأعمالُ التي يُنجِزُها الفرد، بينما في التَّصوُّر المعرفيِّ يُنظر إليها كإستراتيجيَّة لتأطير الأنشطة.
وتَجدُر الإشارةُ إلى أنَّ "مركز الدراسات البيداغوجية للتجريب والإرشاد الفرنسي CEPEC " قدَّم تَصَوُّرًا متكاملاً للاشتغال بالكفايات في التعليم؛ حيثُ عَرَّفها: "تُعرَفُ الكفاية كنَسَقٍ من المعارف المفاهيميَّة والمهاريَّة (العِلْمِيَّة)، والتي تَنتَظِمُ على شكلِ خطاطات إجرائيَّة تكمُنُ داخلَ فئةٍ من الوضعيَّات (المواقف) من التَّعرف على مهمةٍ - مشكلة - وحلِّها بإنجاز (أداء) performance ملائم"[5].
وانطلاقًا من هذا التَّعريف؛ فإنَّ ما ينبغي أنْ يُؤخذَ بعين الاعتبار حين تعريف الكفاية ليس هو السُّلوك كردِّ فعلٍ عضلي أو غُدَدِي، كما يُعبِّر عنه السُّلوكيُّون بل هو التعبيرُ عن المهام؛ لأنَّ الكفاية تُشير إلى القدرة على تنفيذ مهمَّةٍ مُعطاة بطريقة مُرْضِية.
إنَّ التَّدريس المعاصر - إضافةً لكونه عِلْمًا تطبيقيًّا انتقائيًّا مُتطوِّرًا - هو عمليَّةٌ تربويَّةٌ هادفةٌ وشاملة، تأخذ في الاعتبار العوامل المكوِّنة للتَّعلُّم والتَّعليم كافَّةً، ويتعاون خلالَها كلٌّ مِن المعلِّمِ والتلاميذ، والإدارةِ المدرسيَّة، والغُرَفِ الصَّفيَّة، والأسرةِ والمجتمع؛ لتحقيقِ ما يُسمَّى بالأهداف التَّربويَّة والتدريس، إلى جانبِ ذلك عمليةُ تفاعلٍ اجتماعيٍّ، وَسيلَتُها الفكرُ والحواسُّ والعاطفةُ واللُّغة.
والتَّدريسُ موقف يتميَّزُ بالتَّفاعُلِ بين طرفين، لكلٍّ منهما أدوارٌ يُمارسُها؛ من أجل تحقيق أهدافٍ مُعَيَّنة، ومعنى هذا: أنَّ التِّلميذَ لم يَعُدْ سلبيًّا في موقفه - كما لاحظْنَا في مصطلح التَّدريس التَّقليديِّ - إذْ إنَّه يأتي إلى المدرسة مُزَوَّدًا بخبراتٍ عديدة، كما أن لديه تساؤلاتٍ مُتنوِّعةً تحتاجُ إلى إجابات، فالتِّلميذُ يحتاجُ إلى أنْ يَتَعلَّمَ كيف يتعلَّم؟ وهو في حاجةٍ أيضًا إلى تعلُّم مهاراتِ القراءة والاستماع، والنقد وإصدار الأحكام.[6]
فالموقف التَّدريسيُّ يجبُ النظر إليه على نحوٍ كُلِّيٍّ، باعتبار أنَّه يَضُمُّ عواملَ عديدةً تتمثل في: المعلِّمِ، والتلاميذ، والأهداف التي يُرجى تحقيقها من الدرس، والمادة الدراسية، والزمن المتاح، والمكان المخَصَّص للدرس، وما يستخدمه المعلِّمُ من طرقٍ للتَّدريس، إلى جانب العَلاقة - التي ينبغي أنْ تكون وثيقةً - بين المدرسة والبيت، والمحيط الاجتماعيِّ الذي ينتمي له التلميذ.
3 - بيداغوجيا الكفايات ووضعية حلِّ المشكلات:
أ - الخصائص الديداكتيكية[7] لتحليل وضعية (مشكلة).
تبرز أهمُّ الخصائص الديداكتيكية للوضعية (المشكلة)[8] في الخطوات التالية:
ج - مراحل تحليل الوضعية (المشكلة):
وظيفة التقويم:
يرى (أندري شابو) André chab ، أحدُ المهتَمِّين بالحقل (البيداغوجي) أن التعلم المبنيَّ على الوضعيَّات (المشكلات) هو الإطارُ الأفضلُ الذي يُمكِّنُنا من مدى تحليل إدماج عناصر الدرس، فهذه المقاربةُ تسمحُ بقياسِ مدى قدرة التلميذ على الحلِّ المُتْقَن للمشكلات المعَقَّدة.
والوضعيَّةُ (المشكلة) تؤدِّي وظيفةَ التقويمِ حينما تُقَدَّمُ بهدف تقويم قدرة التلميذ على إدماج التَّعَلُّماتِ في سياقاتٍ مختلفة، ووَفْقَ معايير محددة، ويعدُّ النَّجاحُ في حلِّ هذه الوضعيَّة (المشكلة) دليلاً على التَّمكُّن من الكِفَاية.
ويرى المهتَمُّون أنَّ تقويمَ الكفاية يقومُ على أربعةِ أسسٍ هي:
1- استهدافُ الكِفَاية؛ أي: إنَّ الاختبار يتوخَّى معرفة مدى تَبَلْوُر كفايةٍ مُعيَّنة لدى المتعلِّم.
2- الانطلاقُ من وضعيَّة على صيغة مشكلة، ذلك أنَّه على المُقَوِّم اجتنابُ اعتمادِ أنشطةٍ أو تَعَلُّمَاتٍ مفصولةٍ ومُجَزَّأة في عملية التقويم.
3- أنْ تكونَ وضعيَّةُ التَّقويم تنتمي إلى نفس الصنف أو عائلة الوضعيَّات التي تُحَدِّدُ الكفايةَ المستهدفة في التقويم.
4- أنْ تكون وضعيَّةُ التقويم وضعيَّةً دالَّةً بالنسبة للتلميذ؛ أي: إنَّها تحملُ معنًى بالنسبة إليه، وتُحفِّزُه لتعبئة تَعَلُّمَاتِه لأداء المهمة المطلوبة.
5- تجديدُ التَّدريسِ بالكفايات: من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الإدماج.
تطرح العديد من الدِّراسات التَّربويَّة السُّؤالَ التالي:
ما الفرقُ بين بيداغوجيا الأهداف والمقاربة بالكفايات؟
كثيرًا ما تُوصَفُ (بيداغوجيا الكفايات) على أنها تجاوز (لبيداغوجيا الأهداف)، غيرَ أنَّه وَصْفٌ مُجانبٌ للصَّواب؛ إذ يصر الكثير من الباحثين المهتمِّين بالحقل التربوي - الدكتور/ محمد الدريج خاصة - على أنَّ (الكفايات) هي الجيلُ الثاني من الأهداف، كما أنَّ النَّموذجَ الكِفَائِيَّ بالولايات المتحدة الأمريكيَّة تبدو فيه الكفاية أقرب إلى الهدف السُّلوكيِّ؛ حيثُ يُعَرِّفُ (أندرسون) Anderson الكفاية بأنَّها: المعرفة والمهارة أو الموقف؛ حيث يمكن التفوق داخل وضعية خاصة.
كما أنَّ (كزافيي روجيرز) في محاولةٍ أجراها للكفايات، اقترح نموذجًا يَنطلقُ من تقديم الأهداف، قبل أن يتمَّ إدماجُ هذه الأهداف من خلال وضعيَّات، وفي هذا الإطار يقترح (روجيرز) ما يُسمِّيه الهدف الإدماجيَّ النهائيَّ والهدف الإدماجيَّ الوسيط[9]، بل إنَّ هناك مَن يَذهبُ إلى أنَّ ما قدَّمَتْهُ (بيداغوجيا الكفايات) من جديد هو ما نُسمِّيه بـ(إدماج التعلُّمات) وإعطاؤها معنى ضمن (وضعيَّات دالة).
هذه التَّعَلُّمَاتُ التي كانت - حسبَ المقارَبةِ بالأهداف - مُجَزَّأةً وخاليةً من المعنى وغريبةً عن محيطها؛ لهذا فهو انتقال - كما يصفُه المتخَصِّصون - من التَّدريسِ بالمحتويات إلى التَّدريس بالوضعيَّات.
صحيحٌ أنَّ هناك فروقًا جوهريَّةً بين المقاربتين، بَيْدَ أنَّ هذه الفروق لا تقطع بينهما؛ إذْ تُمثل (المقاربةُ بالكفايات) تواصلاً وإغناءً (لبيداغوجيا الأهداف)؛ لذا حاولتْ تجاوزَ نقائص (بيداغوجيا الأهداف) التي تُركز على اكتساب المعارف والمهارات (ماذا نتعلََّم؟)، وتُهْمل العمليَّاتِ الذِّهنية التي تعتمل في ذهن المتعلِّم أثناء التَّعلُّم: ما العمليات الذِّهنية المُوَظَّفة أثناء التَّعلُّم؟ وذلك بالجمع بين الاهتمام بالمحتوى وبالعمليَّات المُنَظِّمة لعملية التعلُّم، من خلال اهتمامها بالمتعلِّم الذي لا يتعلَّم - حَسَبَ مبادئ المقاربة بالكفايات - إلاَّ في (وضعيَّات دالة) يتَمرَّسُ داخلَها بكفاياته، ويدعم Filarsnier هذا الموقف بقوله: "تُعتبر الكفايةُ وسيلةً لاكتساب محتوى المادَّة؛ إذ لا يمكننا تنشيط (الكفاية) من الفراغ، بمعنى: أنه يجب استعمال محتوى المادَّة (موضوع التَّعلُّم) التي تُدمَج داخل سياق يُحدِّد وضعيَّة المهمَّة المقترحة على المتعلِّم؛ وذلك لجعلها (دالةً) بالنسبة إليه".
المعنى البيداغوجي للإدماج (نشاط الإدماج):
Ÿ يفيدُ الإدماجُ (بيداغوجيا) توظيف التلميذ مختلفَ مُكتسباته المدرسيَّة، وتعبئتها (تجنيدها) بشكلٍ مترابطٍ في إطار وضعيَّة ذات دلالةٍ، واعتباره الفاعل الأساسي في إدماج المكتسبات، كما أنه لا يمكن إدماج إلاَّ ما هو مُكتسَب.
Ÿ نشاطُ الإدماج هو نشاط (ديداكتيكي) وظيفته الأساسية جَعل التلميذ يُعَبِّئُ مجموعةً من المكتسباتِ المنفصلة؛ من أجل إدماجها وإعطائها معنى (ربط المكتسبات السابقة بالمكتسبات الجديدة).
Ÿ الموارد (المصادر): هي المعارفُ والمهاراتُ، والمواقفُ والاتجاهات، وكلُّ الوسائلِ المرتبطة بالوضعيَّة وسياقِها، والتي تكونُ ضروريَّةً لبناء الكفاية.
(المفاهيم المرتبطة بالكفاية):
Ÿ الإدماج: ربطٌ بين الموارد المكتَسَبة والمنفصِلَة؛ لغاية تفعيلِها وتوظيفها؛ لتحقيقِ غايةٍ معينة.
(التعاطي مع وضعية (مشكلة):
Ÿ الوضعيَّة: وهي - وَفْقَ كزافيي روجرز - ثلاثٌ:
Ÿ وضعيَّةُ (مشكلة) ديداكتيكية، وضعيَّةُ إدماج، وضعيَّةُ تقويم.
Ÿ المهارة Habilité: التَّمكُّن من أداء مهمة محدَّدةٍ بشكل دقيق، يتَّسمُ بالتناسُق والنجاعة والثبات النسبيِّ (محاكاة، رسم، إنجاز تجربة...).
Ÿ قدرة (capacit) وتتضمن:
التَّمكُّن، والاستعداد، والأهليَّة للفعل، يتطلبُ اكتسابُها وقتًا طويلاً، ويَصعُب قياسُها؛ مثل: (القدرة على التحليل أو التركيب أو النقد...).
Ÿ الأداء أو الإنجاز performance: القيام بمهامٍّ في شكل أنشطةٍ أو سلوكيَّاتٍ آنيةٍ ومحددة، وقابلةٍ للملاحظة والقياس، وعلى مستوى عالٍ من الدِّقَّة والوضوح.
Ÿ الاستعداد aptitude: مجموعةٌ من الصفات الدَّاخليَّة التي تَجعلُ الفرد قابلاً للاستجابة بطريقةٍ مُعيَّنةٍ وقَصْدِيَّة.
الهدف النهائيُّ للإدماج:
يتمثَّلُ الهدفُ النهائيُّ للإدماج المعتمد في مرجعيَّة التَّكوين فيما يلي:
"عند نهاية التَّكوين، يُصبح الطالبُ(ة) الأستاذ(ة) قادرًا على تعبئةِ مُختلف الموارد؛ لتخطيطِ وبَلْوَرةِ، وتدبيرِ وتقويم أنشطةٍ تعليميَّةٍ وتَعَلُّمِيَّة في مختلَف موادِّ ومستويات المدرسة الابتدائية، ووَفْقَ التَّوجيهات الرسمية والبرامج والمناهج المقرَّرة، مع أخذ خصوصيَّاتِ المتعلمين الذاتية والموضوعية بعين الاعتبار، والتَّسلُّح بنظرة نقدية لممارساتِه وبهامشٍ من الحريَّة والإبداع، في أُفُقِ تَحْيِين هذه الممارسات وتطويرها باستمرار".
تنطلق في تحديد الفروق بين (بيداغوجيا الأهداف) و(بيداغوجيا الإدماج أو المقاربة بالكفايات) من الجدول التالي:
جدول يقارن بين (بيداغوجيا الأهداف) و(بيداغوجيا الإدماج)
لئن كشفتْ هذه المقارنةُ عن تواصُلٍ منطقيٍّ بين المقاربتين، فإنَّ (بيداغوجيا الإدماج) تُحاولُ تَفادِي تجزِئة التَّعلُّمات، وتعملُ على إدماج المكتسبات، فتجديدُ البرامج لا يَعنِي إذًا مجرَّد صياغة جديدة للبرامج، ولكنَّه تصوُّرٌ جديدٌ لمنزلة المتعلِّم في العمليَّة التعليمية التعلّمية، باعتباره ذاتًا فاعلةً تُعيد بناء وهيكلة معارفها، انطلاقًا مِمَّا حصل لها من خبراتٍ وتجاربَ مدرسيَّة وغير مدرسية، تساعدُه على حشْدِ قدراتِه وكفاياتِه داخل وضعيَّة اندماجيَّة[10].
ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
[1] البيداغوجيا: معناها علوم التربية، والبيداغوجيا: مصطلح تربوي أصله يوناني، ويعني لغويًّا: العبد الذي كان يرافق الأطفال إلى المدرسة، من الصَّعب إيجاد تعريف محدد للبيداغوجيا.
[2] ((لا تكونوا إمعة، تقولون: إنْ أحسنَ الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا))؛ رواه الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: (2007).
والإمعة: بكسر الهمزة وتشديد الميم، والهاء للمبالغة وهمزته أصليَّة، هو الذي يتابع كل ناعق، ويقول لكل أحد: أنا معك؛ لأنه لا رأيَ له يرجع إليه، وهو المقلد، الذي يجعل دينه تابعًا لدين غيره، بلا رُؤية ولا تحصيل برهان، والمراد هنا: مَن يكون مع من يوافق هواه، ويلائم أَرَبَ نفسه وما يتمناه، يقول: أنا مع الناس: إن أحسنوا لي أو لغيري، فأنا مثلهم، أحسنُ اتِّباعًا لهم وجزاءً لإحسانهم، وإن ظلموا؛ أي: ظلموني، أو ظلموا غيري: فكذلك أظلم على وفق عملهم، واتِّباعًا لهم، وتقليدًا.
[3] بنجامين بلوم: عالم تربوي أمريكي (1913 - 1999)، درس التربية في جامعة بنسلفانيا، وحصل على الدكتوراه في التربية من جامعة شيكاغو سنة 1942، وأصبح عضوًا في لجنة امتحانات جامعة شيكاغو سنة 1940، وعين محاضرًا في التربية في نفس الجامعة سنة 1944، وقد عمل مستشارًا تربويًّا لعدة دول في العالم في مجال التعلم وأهدافه وتقويمه، كان يؤمن بالخبرة المباشرة والتجربة؛ ولذلك كان يطلب من تلاميذه استخدامَ البحث والاستقصاء، وكان يؤمن أنَّ التعلم في أساسه هو جهد يبذل لأجل الاستفادة الكاملة من طاقات المتعلمين، إنَّ التعلم في نظره هو تمرين في التفاؤل، وقد كان هو نفسه متفائلاً، ولكن تفاؤله كان في عمله على تحقيق أهدافه وتحويل طموحاته إلى حقائق ملموسة.
[4] الخطيب، إبراهيم، ودبور مرشد، "أساليب تدريس الاجتماعيات"، ط 2، دار العدوى، الأردن، 1980، ص18-20.
[5] "معجم علوم التربية"، عبدالكريم غريب ومن معه، سلسلة علوم التربية (9 - 10)، منشورات عالم التربية الطبعة: 2، 1998.
- "ما هي الكفايات؟"، هوارد غاردنر وآخرون، إعداد وتعريب: الحسن الحية، عبدالإله شريط، مطبعة بني أزناسن سلا، 2003.
[6] "التربية الإسلامية وبيداغوجية التدريس بالكفايات"، الفريق التربوي الجديد.
[7] الديداكتيك:كلمة من أصل لاتيني تعني طريقة التدريس.
[8] "المقاربات والبيداغوجيات الحديثة"، الفريق التربوي، وزارة التربية الوطنية المغربية، 2004 - 2005.
[9] Xavier Rogiers: une pédagogie de l'intégration 2ème édition De Boeck université.
[10] "مزايا التعليم والتعلُّم وفق المقاربة بالكفايات من بيداغوجيا الأهداف إلى بيداغوجيا الإدماج"،www.korasat.com/file/mazaya.doc
بواسطة: ناديا آمال شرقي
موسوعة التعليم والتدريب
http://www.edutrapedia.illaf.net/ara...e.thtml?id=715
أهلاً بك عزيزي الزائر, هل هذه هي زيارتك الأولى ؟ قم بإنشاء حساب جديد وشاركنا فوراً.
أهلا وسهلا بكـ يا admin, كن متأكداً من زيارتك لقسم الأسئلة الشائعة إذا كان لديك أي سؤال. أيضاً تأكد من تحديث حسابك بآخر بيانات خاصة بك.
النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع: التدريس بين التقليد والتجديد
العرض المتطور
-
19-Dec-2012, 02:45 PM #1موقوف


- تاريخ التسجيل
- Jan 2010
- المشاركات
- 3,698
- معدل تقييم المستوى
- 0









 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس

 إيلاف ترين
إيلاف ترين 




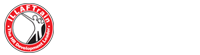
المفضلات